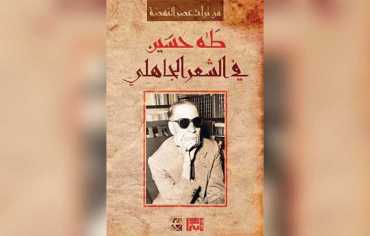الشعر السوري.. من الحداثة إلى الاحتفالية
فجأة، تصدّر الشعر الكلاسيكي المشهد الثقافي في سورية، وبدا الأمر كما لو أنَّ الأرض انشقت لتكشف عن شعراء كانوا مجهولين تماماً، أو معروفين لكنهم مغيّبون. دخل هؤلاء الساحة من بوابة الانتصار على النظام القديم،
وأصبحوا الأكثر حضوراً في الإعلام الثقافي، مهيمنين على المنابر الاحتفالية، واقتربوا أكثر من بؤر الضوء، على حساب الأنماط الشعرية الأخرى.
فبدت القصيدة العمودية وكأنّها النمط الشعري الأوحد، أو على الأقل القائد الفعلي لقاطرة الشعر في سورية بعد سقوط النظام.
وبين التفهُّم لتعلّق الأجواء الاحتفالية بالقصيدة العمودية، والتراجع اللحظي للأنماط الشعرية الأخرى، لا يخلو المشهد العام من افتراضات محتملة، تتعلّق بثأرية القصيدة العمودية لنفسها، ورغبتها في استعادة كرامتها بعد إحساس طويل بالتهميش في الزمن السابق.
وإذا كان السياق السياسي الراهن يساعد في فهم حلول شعراء جدد محل شعراء قدامى كانوا رموزاً للمرحلة السابقة، فإن هذا السياق يبقى قاصراً عن تفسير الحضور شبه الأحادي للشعراء المحسوبين على النمط الكلاسيكي، وغياب القصيدة الحديثة ورموزها عن الساحة الفعلية.
كما لا يكفي تفسير ذلك بملاءمة القصيدة العمودية ـ بخطابها المرتفع ـ للأجواء الاحتفالية، وإن كان ذلك صحيحاً إلى حدّ ما.
ومع اقتراب التفسيرات من فرضية التهميش المتعمد للأنماط الشعرية الأخرى، تنفتح الظنون على وجود نزعة انتقامية في صعود القصيدة العمودية، تتقاطع مع مناخ فكري وفنّي واجتماعي ينسجم مع بنية القصيدة التقليدية أكثر من انسجامه مع الأشكال الشعرية الأخرى.
ما يدفع إلى التساؤل الأوسع: ما مدى ارتباط الشعر السوري المعاصر بالمناخات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي رافقته منذ منتصف القرن الماضي حتى اللحظة الراهنة؟
شهد الشعر السوري المعاصر منذ خمسينيات القرن العشرين تحوّلات متسارعة، تمظهرت في تنوّع أشكال القصيدة. إلى جانب القصيدة العمودية، ظهرت أنماط جديدة أُطلق عليها مجتمعة "الشعر الحديث"، وتتمثل في "قصيدة التفعيلة" و"قصيدة النثر"،
وقد برّرت هذه الأنماط مشروعيتها باختلافها البنيوي والمضموني عن القصيدة التقليدية، متجاوزة الفوارق الشكلانية إلى اختلافات في اللغة والرؤية والنسق الخطابي.
وكانت نظريات التحديث والتجريب الغربية ـ مثل الدادائية، والسريالية، والواقعية الاشتراكية، وغيرها ـ بالإضافة إلى الترجمات الشعرية، قد شكّلت خلفية فكرية للشعر العربي الحديث.
في المقابل، شكّل استقلال سورية مظلّة لتأسيس أشكال شعرية جديدة، متحرّرة من سلطة التاريخ الكلاسيكي التي طالما لامست حدود القداسة في الوجدان الجمعي.
وقد استطاعت القصيدة السورية الحديثة، في فترة قصيرة، أن ترسّخ حضورها في المشهد الشعري من خلال شعراء روّاد، مثل نزار قباني، وأدونيس، ومحمد الماغوط،
ثم تلَتهم كوكبة من شعراء الحداثة مثل محمد عمران، وشوقي بغدادي، وفايز خضور، وممدوح عدوان وغيرهم.
في المقابل، اكتفى الشعر الكلاسيكي بنجومه السابقين، ولم يعد المشهد مهيأً لولادة شعراء كلاسيكيين يحظون بالنجومية كما حصل في القصيدة الحديثة.
ورغم التباينات بين القصيدتين الحديثة والكلاسيكية في الأدوات والتوجّهات، لا سيّما في فترة المد القومي وتشكُّل الوعي الوطني، فإن القصيدة الحديثة لم تتخلّ حينها عن صوت الشاعر الناطق باسم الجماعة حتى نهاية ستينيات القرن الماضي.
ظلّ الشاعر ـ الحديث والتقليدي على السواء ـ يعبّر عن صوت القبيلة في قصيدته.
هكذا، بدا نزار قباني في غزلياته كمن يجسّد صوتاً جماعياً مقهوراً داخل بنية اجتماعية مغلقة، فجاء خطابه المرتفع تعويضاً عن الصوت الخافت. أما في قصائده السياسية، فكان ناطقاً باسم الأمة.
في حين ذهب أدونيس إلى التعبير عن ضمير الجماعة بصوت نَبَوي رؤيوي، كما يدل عنوان مجموعته "مفرد بصيغة الجمع".
أما محمد الماغوط، فكان استثناءً شعرياً حاداً، بقصيدته النثرية المتقشفة لفظياً والغنية جوّاً، مما يجعله تجربة تستحق الوقوف عندها.
وقد أدّت هزيمة حزيران 1967 وتمركز السلطة الفردية في يد حافظ الأسد إلى انكسار الصوت الجماعي في الشعر السوري، ما اضطرّه إلى استعارة ذلك الصوت من الشعر الفلسطيني، المتصاعد حينها في رمزيته ومقاومته.
ومع أن الشعر الفلسطيني دعم قصيدة الحداثة، فقد تحوّل الشعر العمودي في سورية إلى طقس فولكلوري يظهر في المناسبات الرسمية وفي المناهج المدرسية.
خلال سبعينيات القرن الماضي، برزت قصيدة التفعيلة، وخصوصاً عبر شعراء الستينيات، مع استثناءات نوعية مثل رياض الصالح حسين الذي انحاز إلى قصيدة النثر، وترك أثراً لافتاً رغم رحيله المبكر في مطلع الثمانينيات.
ومن نهاية السبعينيات حتى اندلاع الثورة السورية، شهد الشعر السوري تحوّلات متعدّدة، انحصر معظمها في القصيدة الحديثة، فيما بقي الشعر العمودي ضمن أطر ضيقة على هامش المشهد.
وتُعدّ الثمانينيات مرحلة تحول أساسية، شهدت اغتراباً واضحاً للصوت الشعري، وتشتّتاً في الهوية، إلى جانب ازدياد عدد شعراء الحداثة بشكل أفقي.
منذ الثمانينيات، أخذ الشعر السوري يبحث عن هويته ومضامينه الخاصة، لكن تصاعد الاستبداد دفعه نحو التشظي، والغرق في الزخرفة الشكلية، والرمزية المفرطة.
وفي التسعينيات، عاد إلى نظريات التجريب والتأثر بالمدارس الغربية والمترجمات، ما أفقده توازنه الزمني والمكاني لفترة امتدت حتى 2011، رغم استمرار هيمنة الشعر الحديث خلالها.
ومع اندلاع الثورة، خيّم الفضاء السياسي والأمني على الشعر السوري، فاقتربت القصيدة أكثر من السردية، وتخلّت عن الزينة اللغوية، وانحازت إلى الصوت الإنساني العاري من الزخارف.
تماهت موضوعاتها بين الداخل والخارج، وانقسمت تعبيراتها بين شعراء معارضين وآخرين موالين، لكنها للمرة الأولى منذ عقود، فتحت المجال أمام صوت سوري يتشكّل.
كأن الشعر السوري قبل هذه اللحظة، كان يفتقد قضيته، ويبحث عن خلاصه. أما الآن، فقد حرّرته المأساة من الخوف، وأعادته إلى جوهره: أن يقول ما لا يمكن السكوت عنه.
* محمد صارم
كاتب سوري