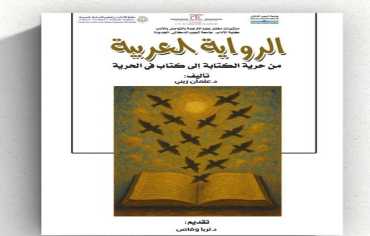خرج الأمراء حفاة.. حكاية الطاعون في بلاد الشام
على رغم كثرة المراجع التي تتناول مرض الطاعون وانتشاره في الشام وآثاره على الناس، فإن التأريخ الحقيقي لذاك الوباء لم يبدأ، على ما يبدو، إلا في عصر الخلفاء الراشدين، وتحديداً في عام 18هـ/639م أيام خلافة عمر بن الخطاب، بحيث شهد ذاك التاريخ معارك شرسة بين المسلمين والروم نتج منها آلاف القتلى، وتزامن معها قحط وجدب تسببا بمجاعة شديدة إلى درجة سُمِّي ذاك العام بــ "عام الرَّمادة"، لأن "الأرض اسودّت من قلة المطر، حتى عاد لونها شبيهاً بالرماد، ولأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها"، بحسب ما ذكر ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ".
هذه البيئة من آلاف القتلى وتفسخ أجسادهم وتعفُّنها، والقحط الكبير، والريح الشديدة، كانت ملائمةً جداً لتعزيز الأوبئة وانتشارها، وهذا ما حدث، إذ انتقل الطاعون، الذي تفشى في بلدة "عمواس" الفلسطينية، التي تقع بين بيت المقدس والرملة، في عموم البلاد الشامية. حتى إن الزبيدي، صاحب "تاج العروس من جواهر القاموس"، كتب عن معنى كلمة عمواس: "وقيل: إنما سُمّي طاعون عمواس، لأنه عمّ وآسى: أي جعل بعض الناس أسوة ببعض"، ومن مفارقة الأقدار أن الزبيدي مات بالطاعون في اليوم ذاته الذي أصيب فيه.
وكان لهذا الطاعون آثارٌ مهلكة. فقد ذكر الواقدي أنه أودى بحياة 25 ألفاً من سكان بلاد الشام وحدها، وقال غيره: 30 ألفاً، ثم انتقل إلى العراق ففتك بأهل البصرة وأهل الكوفة فتكاً ذريعاً.
طاعون الفجأة
من مفارقات مرض الطاعون في بلاد الشام ما ذكره بعض المراجع، ومنها "البداية والنهاية" لابن كثير، و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" للذهبي، و"بذل الماعون في فضل الطاعون" لابن حجر العسقلاني، أنه في عام 87هـ/706م، انتشر ما سُمِّي طاعون الفتيات أو العذارى.
أما سبب التسمية، بحسب جلال الدين السيوطي، أنه أتى لكثرة من مات فيه من النساء والعذارى والجواري. وفي العام ذاته، تفشّى طاعون آخر أطلقوا عليه اسم "طاعون الأشراف"، إذ كان يستهدف أشراف القوم وأكابرهم. وعلى رغم عدم علمية هذا الكلام، إذ إن الوباء لا يفقر بين جنس وآخر، أو بين فقير وغني، أو بين شريف وآخر من عامة الناس، فإنه، وفق كتاب "الطاعون في العصر الأموي: صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية" لأحمد العدوي، فإن "هذا الطاعون ربما كان من أسوأ الطواعين في العصر الأموي عنفاً وشراسة، إذ حصد أرواح أهل الشام حصداً، حتى إن الأحياء كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم يأساً من النجاة، فالتابعي بُشير بن كعب بن أُبيّ الحميري حفر قبراً لنفسه وظل يقرأ فيه القرآن حتى مات في حفرته. وفي هذا دلالة على أن هذا الوباء كان كارثياً إلى درجة تسليم الناجين منه بأنهم مدرَكون"، والأمر ذاته ذكره ابن عساكر في كتابه "تاريخ مدينة دمشق".
ومن غرائب هذا الوباء ما ذكره ابن حجر في "بذل الماعون" تحت مُسمّى "طاعون الفجأة"، بحيث قال "إن طاعوناً عجيباً وقع عام 346هـ/957م، فكثر فيه الموت بالفجأة، حتى إن أحد القضاة لبس ثيابه ليخرج إلى مجلس القضاء فأُصيب بالطاعون فمات وهو يلبس أحد خُفّيْه".
الموت الأسود
وظل ذكر الطواعين التي تصيب بلاد الشام متواتراً كل عدة أعوام، وصولاً إلى الطاعون الذي سُمِّي "الموت الأسود"، الذي بدأ عام 742هـ/1341م، في الصين، ثم انتقل منها إلى سائر شرقي آسيا، ثم تفشى بصورة كبيرة وازداد خطره في عام 749هـ/1348م، حتى لم يترك مكاناً على وجه البسيطة إلّا حل به مُفنياً معظم سكانه.
وفي ذاك العام كان الرحالة المغربي ابن بطوطة في طريق عودته من الصين إلى المغرب، واستقر ردحاً من الزمن في دمشق، ليصبح أحد أهم الشهود على تفشي هذا الوباء الجارف فيها وفي المشرق العربي عموماً، وذكر بعضاً ممّا شاهده من معاناة الناس آنذاك، راصداً عوارض المرض والإجراءات الطبية التي تمت في محاولة لاحتوائه والتخفيف من حدته.
ويقول في كتاب "رحلة ابن بطوطة": "شاهدتُ أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع الثاني عام 749 (هـ) أن ملك الأمراء نائب السُّلطان المملوكي في الشام أرغون شاه أمر منادياً ينادي بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ أحد بالسوق ما يُؤكل نهاراً، فصام الناسُ ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخميس، ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة وسائر الطبقات على اختلافها في الجامع حتى غصّ بهم، وباتوا ليلة الجمعة ما بين مُصلّ وذاكر وداعٍ، ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعاً على أقدامهم وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة، وخرج جميع أهل البلد ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وخرج اليهود بتوراتهم، والنصارى بإنجيلهم، ومعهم النساء والولدان، وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله بكتبه وأنبيائه، وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال، وعادوا إلى البلد فصلوا الجمعة، وخفف الله تعالى عنهم، فانتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد، في وقت وصلت فيه أعدادهم بالقاهرة ومصر إلى 24 ألفاً في يوم واحد".
"يطالعون من كتب الطب الغوامض"
والملاحَظ في وصف ابن بطوطة أن أهالي الشام قاموا بما يشبه الحجر الصحي، منعاً لتفشي الوباء، وما إغلاقهم المطاعم وصيامهم الجماعي سوى إجراءات احترازية ساهمت في تخفيف جبروت الطاعون وإزهاقه مزيداً من الأرواح، وهو ما أثبتته المقارنة مع القاهرة التي لم تتخذ أي خطوات من شأنها الحد من انتشاره.
يقول الباحث ناهد جعفر في دراسته المعنونة بـ"التاريخ الموبوء.. من عمواس إلى كورونا"، والمنشورة في "مجلة الدراسات الفلسطينية" في عددها الـ123 لعام 2020: "إذا عرفنا أن بلاد الشام، لا سيما دمشق، كانت مركز الدراسات الطبية الأول في عصر الزنكيين والأيوبيين، وفيها وُجد أشهر الأطباء في العالم كله مثل ابن النفيس والأسرة الدخوارية وبني النفّاخ وغيرهم، وفيها أنشأ الزنكيون والأيوبيون من قبل عصر المماليك المجمعات الطبية الكبرى مثل البيمارستان النوري والصلاحي وغيرها، أدركنا أن هذا الإجراء الذي اتخذه أمير دمشق المملوكي أرغون شاه أتى على الأرجح من نصيحة لأحد كبار الأطباء الذين تخرجوا في هذه الصروح العلمية، إذ انخفضت نسبة الوفيات إلى 1/12 مقارنة بنظيرتها في القاهرة".
وفي السياق ذاته تذكر المراجع التاريخية أن الناس في دمشق في أثناء الوباء اعتمدوا على طب القدماء أو الاهتمام بأنواع معينة من الطعام وترك أخرى، ضمن ما يمكن أن نسميه اليوم "الطب البديل"، ولعل الشاهد الأهم على ذلك المؤرخ والأديب الحلبي زين الدين بن عُمر، المعروف بابن الوردي، والذي أمضى في هذا الوباء عام 749هـ، وكتب قُبيل وفاته رسالته المعنونة بـ"النبا عن الوبا"، ووصف فيها بلغة أدبية ساخرة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ما اتخذوه آنذاك من وسائل متعددة في مواجهة "الموت الأسود". كما صوّر ابن الوردي في رسالته الطويلة النتائج الخطيرة التي خلّفها هذا المرض، وبيّن مناطق انتشاره، راسماً مسار حركة الوباء، وكيف أنه انتقل مع خطوط التجارة في البحر والبر، وتجاوز أماكن فلم يقع فيها، كمعرة النعمان مسقط رأسه، وعبّر عن ذلك بأسلوب حواري جميل دار بين الطاعون وتلك المدن.
ويقول ابن الوردي: "كما طوى المراحل، ونزل بالساحل، فصاد صيدا، وبغت بيروت كيدا، ثم سدَّد الرَّشْقَ إلى دمشق، فتربَّع وتميَّد، وفتك كل يوم بألف أو أزيَدَ، فأقل الكثرة، وقتل خلقاً ببترة، فالله تعالى يجري دمشق على سنتها، ويطفي لفحات ناره عن نفحات جنتها. ثم مَزَّ المزة، وبرز إلى برزة، وركب تركيب مزج بعلبك، وأنشد في قارة قفا نبك، وغسل الغسولة، وبلغ من كسوف شمس شمسين سوله، وطرح على الجبة برشه، وأزيد على الزبداني نعشه، ورمى حمص بجلل، وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث علل، ثم طلق اللكنة في حماة، فبردت أطراف عاصيها من حِماه، ثم دخل معرة النعمان، فقال لها أنت مني في أمان، حماة تكفي في تعذيبك، فلا حاجة لي بك، ثم سرى إلى سرمين والفوعة، وشنع على السنة والشيعة، ثم أنطى أنطاكيا بعض نصيب، ورحل عنها حياءً من نسيانه ذكرى حبيب، ثم قال لشيرز والحارم لا تخافا مني، فأنتما من قبل ومن بعد في غنى عني، فالأمكنة الردية تصح في الأزمنة الوبية، وأخذ من أهل الباب، أهل الألباب، ثم طلب حلب، لكنه ما غلب،...".
وفي مكان آخر من رسالته يحكي عن أحوال الناس في حلب وكيف تَوَقُّوا من الطاعون: "فلو رأيتَ الأعيان بحلب وهم يُطالعون من كُتب الطب الغوامض، ويكثرون من أكل النواشف والحوامض… وقد لاطفَ منهم مزاجه وعدّل، وبخّروا بيوتهم بالعنبر والكافور والسَّعد والصندل، وتختّموا بالياقوت، وجعلوا البصل والخلَّ من جملة القوت، وأقلّوا من الأمراق والفاكهة، وقرّبوا إليهم الأُترُج (الليمون الطبي) وما شابهه".
"لم يكن الله ليجمعكم علينا والطاعون"
من طرائف ابن الوردي أنه كتب شعراً يقول فيه: "رأى المعرّةَ عيناً زانها حَوَرٌ.. لكنّ حاجبها بالجَوْر مقرونُ/ وما الذي يصنع الطاعونُ في بلدٍ.. في كل يوم له بالظلمِ طاعونُ".
وهناك طرفة أخرى جرت في زمن العباسيين تقارب ما قاله ابن الوردي، إذ للمصادفة البحتة فإن الطواعين التي كانت تقع في أثناء الخلافة الأموية بمعدل طاعون واحد لكل 4 أعوام ونصف عام تقريباً، وهو معدل هائل، توقفت منذ انتهاء الحكم الأموي إلى أيام الخليفة المقتدر بالله (320ه/932م)، وكان الخلفاء العباسيون يمنّون الناس بأن الله رفع عنهم الطاعون بسبب بركة خلافتهم.
ويقول أبو منصور الثعالبي في كتابه "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب": "وقال المنصور يوماً لأبي بكر بن عياش: من بركتنا أن رُفِع عنكم الطاعون! فقال ابن عياش: لم يكن الله ليجمعكم علينا والطاعون".
ويبقى تصوير ابن خلدون في مقدمته من أهم الشهادات الحية عن طاعون الموت الأسود، نفسياً وعمرانياً واقتصادياً، إذ يقول: "نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المئة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيّف الأمم، وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هَرَمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلّص من ظلالها، وفلّ من حدّها، وأوهن من سلطانها، وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالها، وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر، فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدّل الساكن. وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسانُ الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة، والله وارث الأرض ومَن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تَبدّل الخلقُ من أصله، وتحوّل العالم بأسره، وكأنه خَلْق جديد، ونشأة مستأنَفة، وعالَم مُحْدَث".
أما أهم من أرَّخ للطاعون في الدولة العثمانية فهو الفرنسي دانييل بنزاك في دراسة تقع في أكثر من 600 صفحة، ويظهر فيها أن الطاعون ظل متفشياً أعواماً طويلة في الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1850، في أغلبية الولايات العثمانية، وعانت من جرّائه بلاد الشام مدة 76 عاماً كاملة، حصد خلالها كثيراً من الأرواح.
بديع صنيج – صحافي من سوريا